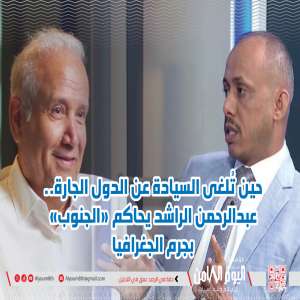"طهران بين مأزق الداخل ورهان الخارج"..
انحسار النفوذ الإيراني في محيطه.. هل يقترب محور المقاومة من التفكك؟
يواجه النظام الإيراني أزمة داخلية متفاقمة بفعل الانهيار الاقتصادي، تهديد آلية الزناد الأوروبية، وتصاعد القمع والانقسامات، ما جعل استقراره هشًا. وفي المقابل يراهن على الميليشيات في العراق ولبنان واليمن لتعويض ضعفه، لكن نفوذه هناك يتراجع أمام ضغوط داخلية وخارجية

احتمالات تفكك محور المقاومة تحت ضغط الأزمات الداخلية والتحولات الإقليمية - صواريخ استعرضها الحوثيون في صنعاء 2023

الملخص: يمر النظام الإيراني بمرحلة مأزومة على مستويين متداخلين: داخليًا، يواجه أزمة اقتصادية خانقة مع تهديد أوروبي بتفعيل آلية الزناد وإعادة العقوبات الأممية، وانقسامات حادة داخل النخبة الحاكمة، وتصاعد موجات القمع التي بلغت ذروتها بتنفيذ أرقام قياسية من الإعدامات، فيما يتنامى الاحتقان الشعبي الذي لم تُخمِده انتفاضة 2022 بالكامل. هذه المعطيات جعلت الداخل الإيراني هشًا وفاقدًا لمقومات الاستقرار.
خارجيًا، يواصل النظام الرهان على الميليشيات في العراق ولبنان واليمن كوسيلة لتعويض ضعفه الداخلي، غير أن هذه الأوراق تتعرض لتآكل تدريجي. ففي العراق تراجعت قبضة الميليشيات تحت ضغط أميركي وشعبي، وفي لبنان برز موقف رسمي غير مسبوق يدعو لحصر السلاح بيد الدولة ما يضع حزب الله أمام تحدٍ وجودي، أما في اليمن فالتقارب السعودي–الإيراني والضغوط الدولية يدفعان نحو تسوية تقلّص دور الحوثيين كورقة إيرانية.
تُظهر هذه التطورات أن مشروع إيران الإقليمي فقد كثيرًا من زخمه، وأن ارتباط بقائه بأذرعه الخارجية أصبح عبئًا أكثر منه مصدر قوة. ومع تضييق الخناق داخليًا وتنامي الرفض الإقليمي والدولي، يقف النظام الإيراني أمام مفترق طرق: إما الانكفاء نحو الداخل والبحث عن تسويات، أو المضي في التصعيد الخارجي بما قد يسرّع انهياره.
المقدمة
تواجه طهران اليوم واحدة من أشد أزماتها الداخلية على الصعد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، في وقت لا يزال نظامها يراهن على أذرعه الميليشياوية في الخارج لتعويض تآكله الداخلي. ففي الداخل الإيراني، تئن البلاد تحت وطأة انهيار اقتصادي متسارع وعزلة دولية خانقة، بينما تتزايد الانقسامات داخل بنية النظام نفسه، ويشتد القمع الأمني لمحاولات التعبير والاحتجاج.
وفي المقابل، يعتمد النظام الإيراني على استراتيجية ”العمق الاستراتيجي“ عبر دعم الميليشيات الموالية له في دول المنطقة (العراق ولبنان واليمن بشكل خاص) أملًا في تثبيت نفوذه الإقليمي وخلق أوراق ضغط يوازن بها تراجعه داخليًا وخارجيًا.
بيد أنّ هذا الرهان الخارجي يصطدم مؤخرًا بتحولات عميقة في مواقف دول الجوار والمجتمع الدولي، مما يضع المشروع الإقليمي الإيراني بأكمله أمام مفترق طرق خطير.
مأزق الداخل الإيراني: اقتصاد منهار وانقسامات وقمع متصاعد
تعاني إيران أزمة اقتصادية خانقة غير مسبوقة. فقد أدى استمرار العقوبات الأميركية والدولية وسوء الإدارة الاقتصادية إلى انهيار قيمة العملة الوطنية وارتفاع التضخم لمستويات قياسية، فضلًا عن تفشي البطالة والفقر. ورغم مرور عامين على وصول إبراهيم رئيسي للرئاسة بوعد إنعاش الاقتصاد، ما زالت البلاد ترزح تحت الركود؛ بل تفاقمت الأوضاع مع تهديد الدول الأوروبية بتفعيل “آلية الزناد” لإعادة فرض العقوبات الأممية على طهران.
ففي رسالة مشتركة إلى الأمم المتحدة في أغسطس 2025، لوّحت فرنسا وبريطانيا وألمانيا بتفعيل آلية «سناب باك» لإعادة كل عقوبات الأمم المتحدة ما لم تعد إيران فورًا إلى المفاوضات النووية.
هذا التهديد الأوروبي الجدي وضع النظام الإيراني أمام مأزق اقتصادي أكبر، إذ يعني إعادة عزل طهران ماليًا ونفطيًا على المستوى الدولي في وقت تعاني خزينتها من عجز شديد.
سياسيًا، يواجه النظام الإيراني تصدعات داخلية متنامية. التقارير الواردة من طهران تصف مشهدًا من “صراع العقارب” داخل أروقة الحكم، حيث تتصارع أجنحة السلطة على النفوذ وسط الأزمات المتفاقمة.
كشفت صحف إيرانية في ربيع 2025 عن تبادل اتهامات علني بين مسؤولين، ما عرى حجم التناقضات بين مصالح الشخصيات النافذة حتى بات كل منهم يسعى لحماية مكاسبه الضيقة على حساب المصلحة العامة.
ووصفت صحيفة إيرانية هذا السلوك بأنه “ديكتاتورية صغار” يمارسها بعض قادة النظام.
ويشير محللون إلى أن هذه الصراعات ليست مجرّد خلافات عابرة، بل تعكس أزمة بنيوية حادة تهدد تماسك النظام برمته. فالتنافس المحموم على السلطة يعطّل قدرة النظام على اتخاذ قرارات موحّدة في مواجهة الأزمات، بينما يؤدي استمرار تدهور الاقتصاد وارتفاع الأسعار إلى تأجيج الاستياء الشعبي وكسر ما تبقى من ولاء أو خوف تجاه رموز الحكم.
على الصعيد الاجتماعي والشعبي، تمر إيران بحالة غليان تحت السطح رغم نجاح السلطة – مؤقتًا – في إخماد الانتفاضة الواسعة التي اندلعت خريف 2022 عقب مقتل الشابة مهسا أميني. تلك الاحتجاجات غير المسبوقة على سياسة فرض الحجاب الإلزامي اتسعت لتشمل فئات اجتماعية ومناطقية مختلفة، واستمرت لعدة أشهر، ما جعلها أحد أكبر التحديات التي واجهت النظام منذ قيامه عام 1979.
ورغم حملة القمع الشرسة التي واجهت بها السلطات حركة “المرأة، الحياة، الحرية” واعتقال الآلاف وإعدام بعض المتظاهرين، إلا أن جذوة الغضب لم تنطفئ تمامًا.
يشير مراقبون إلى أن الاحتقان الشعبي ما زال حاضرًا بقوة تحت السطح، ويمكن أن يشتعل مجددًا في أية لحظة كلما سنحت فرصة أو تراكمت شرارة جديدة.
وما يدلل على ذلك هو استمرار التحركات المطلبية المحدودة والإضرابات العمالية والاحتجاجات المحلية بين حين وآخر في مناطق شتى من إيران، رغم الترهيب الأمني.
لقد صعّد النظام من سياسة القمع الداخلي إلى مستويات غير معهودة في محاولة يائسة لردع الشارع. فبحسب منظمات حقوقية دولية، نفّذت إيران خلال عام 2024 وحده ما لا يقل عن 975 حكم إعدام – وهو رقم صادم يمثل الأعلى منذ سنوات طويلة.
وقد دانت فرنسا وشركاؤها الأوروبيون هذا الرقم القياسي من الإعدامات بوصفه “رمزًا للقمع الوحشي” الذي يمارسه النظام لإسكات كل من يجرؤ على التعبير عن تطلعات الشعب الإيراني المشروعة للحرية.
وتنفيذ هذا العدد الهائل من الإعدامات – بزيادة 17% عن العام السابق – يؤكد أن السلطات في طهران تعتمد بشكل متزايد على ترهيب المواطنين وإشاعة مناخ الخوف لبسط السيطرة.
أضف إلى ذلك عودة شرطة الأخلاق ودورياتها لضبط لباس النساء بقوانين أشد صرامة، وإقرار البرلمان مؤخرًا مشروع قانون يفرض عقوبات قاسية (قد تصل إلى السجن لعشر سنوات) على مخالفي قواعد الحجاب والسلوك “الإسلامي”.
هذه السياسات القمعية مؤشر واضح على ارتباك النظام وعجزه عن تقديم حلول لأزمات الناس، فلجأ إلى المزيد من القهر لإخماد أي صوت معارض.
رغم نجاح القبضة الأمنية في منع تكرار مشهد المظاهرات الحاشدة خلال الأشهر الماضية، إلا أن الفجوة بين النظام والشعب اتسعت إلى حدٍّ غير مسبوق. فقد باتت شرائح واسعة من الإيرانيين تشعر بالإحباط والاغتراب عن النظام الحاكم. ظهر ذلك جليًا في مناسبتين: أولاهما انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية الماضية (فبراير 2020) إلى نحو 42% فقط، وهي أدنى نسبة منذ ثورة 1979، ويتوقع المراقبون عزوفًا أكبر في الانتخابات التشريعية المقررة في مارس 2024 مع اتساع مشاعر السخط وعدم ثقة الجمهور بجدوى صناديق الاقتراع. وثانيهما في ضعف الإقبال الشعبي على التظاهرات التي دعا إليها النظام تأييدًا للفلسطينيين أثناء حرب غزة 2023؛ إذ خرجت مسيرات خجولة مقارنة بتوقعات النظام، ما اعتُبر دليلًا على تزايد الفجوة بين السلطة والمجتمع.
كذلك أظهر استطلاع رأي داخلي (سُربت نتائجه بشكل غير رسمي) أن نسبة متنامية من الإيرانيين تحمل النظام مسؤولية تدهور المعيشة وتطالب بتغيير سياسي جذري بدلًا من الاستمرار بإنفاق موارد البلاد على مغامرات خارجية.
خلاصة المشهد الداخلي أن نظام الجمهورية الإسلامية بات محاصرًا بأزماته: اقتصاد يقترب من حافة الانهيار، وسلطة منقسمة على ذاتها، وشرعية متآكلة أمام شارع يغلي بالغضب المكتوم. كل ذلك يجعل استقرار النظام هشًا ومهددًا باهتزازات عنيفة إذا ما تراكمت الضغوط الداخلية مع الضغوط الخارجية الآخذة في التصاعد. وفي مواجهة هذا المأزق الداخلي الخانق، يلوذ النظام الإيراني بما يعتبره طوق النجاة الأخير له: تصدير أزماته إلى الخارج عبر توسيع نفوذه الإقليمي والرهان على الميليشيات الحليفة لخلق ساحات اشتباك تبعد الأنظار عن أزمته الداخلية وتمنحه أوراق مساومة جيواستراتيجية.
رهان الميليشيات في الخارج: تمدد إقليمي تحت الضغط
على مدى عقود، تبنّت طهران سياسة بناء محور إقليمي يدور في فلكها كجزء من عقيدتها الأمنية القائمة على “تصدير الثورة” وتعزيز “العمق الاستراتيجي”. جوهر هذه الإستراتيجية هو الاعتماد على جماعات مسلحة موالية لها في دول الجوار لمد نفوذها الإقليمي، وممارسة الضغط غير المباشر على خصومها، وفي الوقت نفسه اكتساب أوراق قوة تستخدمها للمساومة على طاولة التفاوض الدولية في الملفات الشائكة كبرنامجها النووي وصواريخها الباليستية.
وقد برزت ثلاث ساحات أساسية لنشاط إيران الإقليمي خلال السنوات الماضية: العراق ولبنان واليمن. في هذه البلدان، استثمرت طهران الكثير من الموارد السياسية والمالية – وحتى البشرية – لدعم ميليشيات مسلحة تدين بالولاء لها بشكل أيديولوجي وعسكري. وراهن النظام الإيراني على هذه “الوكالة بالقتال” لتحقيق عدة أهداف: ملء أي فراغ ينشأ في تلك الدول لمنع خصومه من استغلاله، وتطويق خصومه الإقليميين (خاصة السعودية وإسرائيل) عبر تطويقهم بجبهات نشطة، إضافة إلى استخدام تلك الميليشيات كورقة ضغط وتهديد يمكن تحريكها متى ما أرادت طهران تحسين شروط التفاوض أو الرد على أي استهداف مباشر لها. بيد أن التطورات الأخيرة تشير إلى أن هذا الرهان الخارجي يواجه تحديات متصاعدة؛ فبيئة هذه الدول لم تعد تتقبل كما السابق وجود ميليشيات مسلحة خارج نطاق الدولة، كما أن ميزان القوى الإقليمي بدأ يميل إلى تشكيل موقف جماعي أكثر صلابة ضد التدخلات الإيرانية. وفيما يلي نستعرض حال الإستراتيجية الإيرانية في كل من العراق ولبنان واليمن، وكيف تغيّرت المعطيات على الأرض بما يقوّض نفوذ طهران أو يحدّ منه.
في العراق: يُعدّ العراق تقليديًا ساحة النفوذ الأولى لإيران وعمقها الإستراتيجي الأهم عربيًا، بحكم الجوار الجغرافي والروابط المذهبية مع غالبية شيعية في الجنوب والوسط. فمنذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، سارعت طهران إلى ملء الفراغ في العراق من خلال رعاية العشرات من الميليشيات والتنظيمات المسلحة، التي تجمّعت لاحقًا تحت مظلة الحشد الشعبي.
لعبت هذه الميليشيات الموالية لإيران دورًا بارزًا في محاربة تنظيم داعش بين 2014 و2017، ولكنها تحولت بعد ذلك إلى ما يشبه الجيش الرديف الذي يوازي قوات الدولة ويفرض أجندة طهران في البلاد. واستطاعت إيران عبر نفوذها الأمني والمذهبي، وولاء قيادات فصائل معروفة بعلاقتها المباشرة بفيلق القدس، أن تجعل من الحشد الشعبي أبرز أدوات هيمنتها على القرار العراقي. كما تغلغل النفوذ الإيراني في مفاصل الدولة العراقية عبر أحزاب “الإطار التنسيقي” الشيعي، بحيث أصبح تعيين رؤساء الوزراء وتشكيل الحكومات في بغداد لا يتم غالبًا إلا بمباركة غير معلنة من طهران.
على أن الأمور في العامين الأخيرين لم تجر تمامًا لصالح إيران داخل العراق. إذ تراجع النفوذ الإيراني في بعض الأوجه بشكل ملحوظ، وظهرت مؤشرات على وهن القبضة الإيرانية حتى ضمن بيئتها الحاضنة التقليدية. فعلى سبيل المثال، خلال المواجهة العسكرية القصيرة بين إيران وإسرائيل في يونيو 2025 (التي استمرت 12 يومًا)، لوحظ أن الميليشيات العراقية الموالية لطهران التزمت قدرًا كبيرًا من ضبط النفس ولم تبادر إلى فتح جبهة ضد الوجود الأميركي في العراق أو ضد خصوم إقليميين.
اعتُبر هذا الموقف مؤشرًا على ضعف تلك الميليشيات أو على الأقل إدراكها لكلفة أي مغامرة في ظرف إقليمي ودولي معقّد. ويعلق أحد أبرز الخبراء الأميركيين في الشأن العراقي مايكل نايتس بالقول إن لحظة ما بعد تلك الحرب القصيرة مثّلت “فرصة لتوسيع النفوذ الأميركي في العراق… وتقليص النفوذ الإيراني”. ويشير نايتس تحديدًا إلى ما وصفه بضعف الفصائل الموالية لإيران هناك وفقدانها جزءًا من هيبتها السابقة.
جانب آخر يقلق طهران في العراق يتمثل في تضاؤل بعض أوراق الضغط التقليدية بيدها. فقد درجت إيران لسنوات على استخدام حاجات العراق الحيوية – كاستيراد الكهرباء والغاز – كورقة ابتزاز سياسي. إذ يعتمد العراق بدرجة كبيرة على أمدادات الطاقة الإيرانية لتعويض نقص إنتاجه الوطني، وكانت طهران تهدد أو تماطل أحيانًا في إمداد بغداد بالكهرباء لإيصال رسائل ضغط. لكن العقوبات الأميركية على إيران قيّدت هذه اللعبة؛ فمنذ 2020 اشترطت واشنطن وضع أموال مدفوعات العراق لإيران في حساب مصرفي مراقَب، ما قيّد قدرة طهران على تحصيل عائدات كبيرة. وفي 2023 وتحديدًا بحلول مارس، توقفت تمامًا واردات الكهرباء الإيرانية إلى العراق بعد تشدد أميركي في منح الإعفاءات.
النتيجة أن إحدى أبرز أدوات نفوذ إيران في العراق اهتزّت، وانعكس ذلك سريعًا على الشارع العراقي: موجات حرّ صيفية قاسية وانقطاع طويل للكهرباء في بغداد ومحافظات الجنوب، مما فجّر احتجاجات شعبية في مدن عراقية عدة صيف 2025 تندد بتقصير الحكومة العراقية وتعزو ذلك ضمنًا إلى الارتهان لمزاج طهران. ومما زاد الطين بلّة أن الإيرانيين سعوا لعرقلة أي بدائل؛ فحين حاولت حكومة حيدر العبادي عام 2018 توقيع مذكرة مع السعودية لاستجرار الكهرباء، مارست طهران ضغوطًا شديدة لإفشال الاتفاق حفاظًا على احتكارها لإمداد العراق بالطاقة.
لكن اليوم، بدعم أميركي وعربي، شرع العراق في ربط شبكته الكهربائية بشبكات الخليج والأردن ومصر، بما يخفف اعتماده المستقبلي على إيران ويحدّ من تأثير سلاح الكهرباء الإيراني. يُضاف إلى ذلك تصاعد الشعور الوطني العراقي ضد الهيمنة الإيرانية، والذي بدا جليًا في انتفاضة أكتوبر 2019 عندما هتف المتظاهرون الشيعة قبل السنّة ضد النفوذ الإيراني وأحرقوا القنصلية الإيرانية في كربلاء.
واستمر هذا المزاج السيادي خلال أزمة تشكيل الحكومة في 2022 حين رفض التيار الصدري وأنصاره علنًا استمرار تحكم طهران بمفاصل القرار العراقي.
يدرك صانع القرار الإيراني أن العراق، برغم كل ما استثمر فيه من نفوذ، قد لا يظل ساحة طيّعة في المستقبل. وتشير تقارير إلى أن المرشد علي خامنئي يعتبر العراق بمثابة “المعقل الإقليمي الأخير” لنظامه بعد سلسلة انتكاسات لمحور نفوذه.
فإيران شهدت تراجعًا حادًا لنفوذها في سوريا مؤخرًا (سنتطرق لذلك لاحقًا)، كما ضُربت ذراعها اللبنانية (حزب الله) بضربات سياسية وأمنية موجعة، فلم يبقَ لها – على حد وصف صحيفة ستاره صبح الإيرانية – سوى العراق لتستميت في الحفاظ عليه. لذلك أرسل خامنئي قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني في زيارة سرية إلى بغداد قبل أشهر، هدفها – وفق تسريبات الصحافة – تنسيق إخفاء مؤقت للميليشيات الموالية لإيران عن المشهد وتهدئة تحركاتها.
وجرت تلك المفاوضات – بحسب مصادر كردية عراقية – تحت ضغط أميركي مباشر، وتركزت على إيجاد صيغة “لتجميد نشاط الميليشيات” ريثما تهدأ العاصفة.
هذه التطورات تدل على أن يد طهران في العراق لم تعد مطلقة كما كانت، وأنها اضطرت مكرهة إلى تكتيكات دفاعية للحفاظ على نفوذها هناك، في مواجهة ضغوط أميركية وغليان شعبي عراقي واصطفاف إقليمي رافض لهيمنة إيران.
في لبنان: يمثل المشهد اللبناني نموذجًا صارخًا لتداخل مشروع إيران الإقليمي مع أزمات دولة عربية. فمنذ مطلع الثمانينيات، رعت إيران تأسيس جماعة حزب الله الشيعية المسلحة، والتي نمت سريعًا لتصبح قوة عسكرية وسياسية تتغلغل في الدولة اللبنانية وتفوق قدرات الجيش النظامي. وبفضل التمويل والتسليح والتدريب الإيراني المستمر، تحول حزب الله إلى ما يسميه مناصروه “ذراع المقاومة” ضد إسرائيل، وأيضًا وسيلة إيران لفرض أجندتها الإقليمية على حساب سيادة لبنان.
لعقود، راهنت طهران على حزب الله كأهم ورقة لها في بلاد الشام: فهو يوفر لها نفوذًا مباشرًا على الحدود الإسرائيلية، ويؤمّن لطهران موطئ قدم على البحر المتوسط، ويمنحها شبكة علاقات وتأثير في المعادلة السياسية اللبنانية الداخلية تمنع قيام أي حكومة معادية لها في بيروت.
بيد أن السنوات الأخيرة حملت متغيرات أضعفت قبضة حزب الله تدريجيًا، ورفعت كلفة دوره كوكيل لإيران. فمن جهة، يعاني لبنان منذ 2019 انهيارًا اقتصاديًا غير مسبوق جعل غالبية السكان تحت خط الفقر، وأحد أسباب هذه الكارثة عزلة لبنان عن محيطه العربي والدولي بسبب هيمنة حزب الله على قراره.
ومن جهة أخرى، أدى الفراغ الرئاسي المستمر منذ أواخر 2022 وشلل المؤسسات إلى تنامي الدعوات الداخلية – حتى من بعض الحلفاء السابقين – إلى إعادة النظر في وضعية حزب الله وسلاحه. الجديد الأبرز هو تغير لهجة الدولة اللبنانية الرسمية حيال سلاح حزب الله والتدخلات الإيرانية. فمع بدايات صيف 2025، تبلورت في بيروت معادلة سياسية غير معهودة قوامها رئيس جمهورية مدعوم دوليًا (الجنرال جوزيف عون) ورئيس حكومة إصلاحي (القاضي نواف سلام)، اتفقا على أولوية استعادة سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها. وفي 7 أغسطس 2025 رأس الرئيس عون اجتماعًا حكوميًا خُصص لمناقشة خطة لنزع سلاح جميع الفصائل خارج إطار الجيش قبل نهاية العام.
وألقى عون خطابًا تاريخيًا وصف بـ“غير المسبوق” طالب فيه “بسحب سلاح جميع القوى المسلحة وتسليمه للجيش اللبناني”، معتبرًا أنه لا يمكن بناء دولة حديثة مستقرة بوجود سلطات عسكرية موازية. ترافق ذلك مع تكليف رسمي للجيش بإعداد خطة تنفيذية لجمع السلاح غير الشرعي، في إشارة واضحة إلى سلاح حزب الله.
وعلى خط موازٍ، خرج موقف حكومي لبناني حازم ضد التصريحات الإيرانية المستفزة؛ فقد أدلى نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بتصريح في طهران مؤخرًا أكد فيه دعم إيران لقرار حزب الله بالاحتفاظ بسلاحه معتبرًا أن “قرار السلاح شأن يعود للحزب نفسه” وأن الدعم الإيراني له “مستمر عن بُعد”. قوبلت هذه التصريحات برد شديد اللهجة من الخارجية اللبنانية التي اعتبرتها “تدخلًا غير مقبول في الشؤون الداخلية واعتداءً على السيادة الوطنية للبنان”، وأكدت أن مسألة سلاح حزب الله شأن لبناني صرف سيتم حله عبر المؤسسات الدستورية اللبنانية. شكل هذا الموقف الرسمي اللبناني تطورًا لافتًا، إذ إنها المرة الأولى التي يصدر فيها عن الدولة اللبنانية نقد مباشر لدور إيران الداعم لحزب الله بهذا الوضوح.
لم يكن الموقف اللبناني الرسمي ليشتد بهذا الشكل لولا تغيّر موازين القوى إقليميًا وتراجع زخم نفوذ إيران في المنطقة عمومًا. فطهران التي كانت تبدو قبل سنوات واثقة من إحكام سيطرتها عبر حزب الله، وجدت نفسها في الآونة الأخيرة تخسر عدة أوراق في “محور المقاومة” الذي تتزعمه.
فبعد حرب غزة الأخيرة خريف 2023 (عملية طوفان الأقصى) اختارت إيران عدم الانخراط المباشر وتجنّبت فتح جبهة جنوب لبنان عبر حزب الله إلا بحدود مدروسة، ما اعتُبر تراجعًا تكتيكيًا خشية مواجهة أوسع مع إسرائيل.
ورغم استمرار الخطاب الإيراني عن “وحدة الساحات” بين غزة وبيروت ودمشق وصنعاء، بدت طهران حريصة على عدم تجاوز خطوط حمراء قد تفجّر حربًا شاملة لا ترغب بها.
أضف إلى ذلك سلسلة الضربات الإسرائيلية الموجعة للوجود الإيراني في سوريا خلال 2022–2023، والتي أسفرت عن اغتيال قيادات بارزة من الحرس الثوري وفصائل موالية لإيران، مما أضعف تموضع طهران في بلاد الشام.
كما جاءت الانفراجة العربية مع الحكومة السورية (عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية في مايو 2023) مشروطة بالحدّ من النفوذ الإيراني هناك، بما في ذلك تفكيك شبكات تهريب المخدرات التي يديرها مقربون من إيران وحزب الله.
وفعلاً، بعد تغير المعادلة في دمشق نهاية 2024 واتفاق وقف إطلاق النار هناك، قامت سلطات سورية جديدة – بدعم عربي – بشن حملة غير مسبوقة على أوكار تصنيع الكبتاغون وتهريب السلاح التي كانت تديرها ميليشيات تابعة لإيران وحزب الله في مناطق الحدود السورية اللبنانية، وتمت مصادرة ترسانة ضخمة من الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية الصنع بحجم يكافئ مستودع أسلحة يمتد على خمسين ملعب كرة قدم.
هذا التطور قلّص موردًا تمويليًا وإستراتيجيًا هامًا لإيران ووكلائها، وأظهر أن نفوذ طهران في سوريا لم يعد مطلق اليدين.
في ظل هذه المعطيات، يجد حزب الله نفسه أمام واقع جديد لم يشهده منذ تأسيسه: ضغط داخلي وخارجي متزامن لنزع سلاحه أو على الأقل تحجيم دوره.
داخليًا، يرزح الحزب تحت عبء اتهامه بأنه مسؤول عن العزلة العربية والدولية للبنان وعن جانب كبير من الانهيار المالي بسبب مغامراته العسكرية الخارجية وهيمنته على القرار اللبناني. حتى داخل بيئته الشيعية، بدأ يتسرّب بعض التململ المكتوم من أُسر لبنانية أرهقها الوضع الاقتصادي ولا ترى مقابلًا لتضحيات أبنائها في ساحات القتال بسوريا واليمن سوى مزيد من الفقر والعقوبات. وخارجيًا، هناك إجماع عربي ودولي غير مسبوق على ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بلبنان (لا سيما القرار 1559) والذي يدعو صراحة إلى نزع أسلحة جميع الميليشيات اللبنانية وبسط سيطرة الدولة وحدها على أراضيها. في هذا السياق يمكن فهم مغزى زيارة مسؤولين إيرانيين كبار لبيروت مؤخرًا (مثل زيارة علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى السابق في أوائل أغسطس 2025) بأنها محاولة من طهران للاستطلاع والضغط حفاظًا على نفوذها التقليدي. لكن المراقبين أجمعوا أن زيارة لاريجاني لم تكن ناجحة؛ إذ قوبل برفض لبناني واضح لأي مساس بالسيادة، وبدا الرجل كمن لا يدرك حجم التحولات الطارئة على النفوذ الإيراني في لبنان.
لقد تغيرت قواعد اللعبة
لبنان الرسمي اليوم يبعث برسالة صريحة لطهران أن ورقة حزب الله لم تعد مطلقة اليد، وأن زمن استخدام لبنان كساحة مفتوحة لحروب الآخرين يشارف على النهاية. وإذا ما نجح لبنان – بدعم دولي وعربي – في تحجيم دور حزب الله العسكري، فسيكون ذلك ضربة موجعة للمشروع الإقليمي الإيراني؛ فحزب الله طالما كان جوهرة التاج في نفوذ إيران الخارجي، وفقدانه لقوته أو انضوائه تحت جناح الدولة اللبنانية سيفقد طهران أداة رئيسية كانت تراهن عليها في مواجهة إسرائيل وتوازن الردع.
في اليمن: شكّلت الساحة اليمنية على مدى العقد الأخير ملعبًا آخر لطموحات إيران الإقليمية وصراعها بالوكالة مع خصومها الخليجيين. فمنذ سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين) على صنعاء وأجزاء واسعة من شمال اليمن عام 2014 بدعم إيراني، رأت طهران في الحوثيين حليفًا عقائديًا وسياسيًا يتيح لها موطئ قدم في الخاصرة الجنوبية للسعودية وعلى مقربة من الممرات الملاحية الدولية في البحر الأحمر. وعلى غرار حزب الله في لبنان، تولّت إيران تسليح الحوثيين وتطوير ترسانتهم من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة التي استُخدمت لضرب العمق السعودي والإماراتي خلال سنوات الحرب.
ووفرت خبراء من الحرس الثوري لتدريبهم على تكتيكات حرب العصابات وصناعة المتفجرات، بل وأُرسل سفير إيراني إلى صنعاء بشكل سري (حسن إيرلو في أكتوبر 2020) لإدارة التنسيق العسكري والسياسي مع الحوثيين.
وبفضل هذا الدعم، أصبح الحوثيون لاعبًا إقليميًا بالوكالة عن طهران، حيث هددوا أمن الخليج وحرية الملاحة، ورسخوا سردية “محور المقاومة” عبر رفع شعارات معادية لأميركا وإسرائيل انسجامًا مع خطاب إيران وحزب الله.
لكن مشهد اليمن بدأ يشهد تحولًا مهمًا ابتداءً من عام 2023. فإطالة أمد الحرب لما يقرب من ثماني سنوات أنهكت الجميع وولّدت ضغوطًا دولية هائلة لوضع حدٍ لها. وفي مارس 2023، حصل تطور مفصلي بإعلان اتفاق بكين لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية برعاية الصين. هذا التقارب الإيراني – السعودي انعكس مباشرة على ملف اليمن بوصفه ساحة الصراع الأكثر سخونة بينهما. وبالفعل، بعد أسابيع قليلة، استضافت العاصمة العُمانية مسقط محادثات غير معلنة بين وفد سعودي رفيع وممثلين عن جماعة الحوثي بوساطة عُمانية، تمخضت عن تفاهمات أولية لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. تلتها زيارة علنية لوفد سعودي إلى صنعاء في أبريل 2023 للبحث في خارطة طريق لإنهاء الحرب، بما في ذلك مرحلة انتقالية يمنية وحل سياسي يضمن تمثيل الحوثيين في الحكم مقابل تخليهم عن السلاح الثقيل والصواريخ. ورغم أن هذه المفاوضات تعثرت مرارًا أمام تعنّت الحوثيين ورفعهم سقف مطالبهم – إلى حد التلويح بالعودة إلى الحرب في منتصف 2023 – إلا أن المسار التفاوضي لم ينقطع. ويُنظر إليه دوليًا باعتباره الأقرب منذ سنوات لوضع أسس سلام دائم في اليمن.
هذا التحول لم يكن ليحدث دون تبدّل في حسابات الأطراف الراعية للحوثيين وأولهم إيران. فطهران – بعد اتفاقها مع الرياض – تجد مصلحة في تهدئة الجبهة اليمنية لتحصيل مكاسب أوسع من التقارب مع الخليج، كجذب الاستثمارات وتحسين اقتصادها المتداعي. وهي تدرك أن استمرار الحرب يعرقل أي انفراجة مع السعوديين ويمكن أن يُستخدم ضدها في المحافل الدولية. من هنا برزت لهجة إيرانية جديدة تشجع على الحل السلمي في اليمن، إذ صرح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن إيران تؤيد أي حوار يمني – يمني ويهمها وحدة اليمن واستقراره. ومع أن هذه التصريحات أتت في سياق المجاملة الدبلوماسية للسعودية، فإن اختبار صدقية إيران الفعلية يظهر في سلوكها الميداني. لقد لاحظ المراقبون بضع إشارات إيجابية: فبعد وفاة سفيرها في صنعاء حسن إيرلو أواخر 2021 (بفيروس كورونا)، لم تسعَ طهران إلى تعيين خلف له، ربما تفاديًا لاستفزاز الرياض وإفشال التقارب. كما خفّ بشكل واضح تهريب شحنات الأسلحة الإيرانية إلى اليمن عبر البحر منذ الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة في 2022، حيث ضبطت البحرية الأميركية مرات أقل من سفن السلاح مقارنة بالسنوات السابقة.
وبدا أن إيران تضغط بهدوء على الحوثيين لعدم استهداف العمق السعودي منذ وقف إطلاق النار؛ فالمفارقة أنه منذ بدء الهدنة في أبريل 2022 لم يطلق الحوثيون أي صاروخ باليستي نحو السعودية أو الإمارات، مما يُفهم أنه قرار استراتيجي له صلة بتفاهمات غير معلنة بين طهران والرياض.
في المقابل، زاد وعي الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا وحلفائها بمخاطر الدور الإيراني، وباتوا يشترطون علنًا تقليص نفوذ طهران في أي تسوية سلام. فقد أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي أن “اختبار صدق النوايا الإيرانية يجب أن يُترجم على أرض الواقع بسحب خبرائها العسكريين من اليمن”، معتبرًا أن الحوثيين مجرد واجهة وأن من “يصنع ويطور الصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف اليمنيين هم خبراء النظام الإيراني”.
كما شدد مسؤولون يمنيون وسعوديون على ضرورة قطع الصلة بين الحوثيين وإيران كجزء من ترتيب إنهاء الحرب، بحيث لا تتحول اليمن إلى قاعدة صواريخ إيرانية على حدود الجزيرة العربية مستقبلًا.
ومع أن الحوثيين ينفون تبعيتهم لطهران ويزعمون استقلال قرارهم، إلا أن الوقائع دحضت ذلك مرارًا – ليس أقلها توافد المبعوثين الأمميين إلى مسقط وطهران في كل منعطف تفاوضي للظفر بمباركة الإيرانيين على ما يوافق عليه الحوثيون.
وحتى خلال محادثات مسقط الأخيرة نهاية 2022، عقد وفد حوثي لقاءات مع وزير الخارجية الإيراني نفسه بحضور الوسطاء العُمانيين، مما أكد أن مفاتيح قرار الحرب والسلام ليست بالكامل في صنعاء بل أيضًا في يد الحرس الثوري بطهران.
هكذا إذن، تبدو الجبهة اليمنية مرشحة للوصول إلى تسوية تضع حدًا للحرب، لكن تلك التسوية – إن حصلت – ستأتي على حساب تقليص نفوذ إيران هناك. صحيح أن النفوذ الإيراني لن يختفي بين ليلة وضحاها نظرًا للروابط العقائدية مع قيادات الحوثيين الذين يرون في خامنئي ولي أمر المسلمين ويتبنون شعارات الثورة الإيرانية حد إدراج اللغة الفارسية في مناهج صنعاء، بيد أن انتهاء الحرب وتشكيل حكومة جامعة في اليمن سيحرمان طهران من إحدى ساحات ابتزازها الإقليمية ضد خصومها الخليجيين.
فلطالما استخدمت إيران معاناة اليمن كورقة دعائية لمهاجمة السعودية دوليًا، وزعزعة أمن المملكة عبر هجمات الحوثيين. فإذا تحقق السلام، ستخسر تلك الورقة بمعظم أبعادها.
أضف إلى ذلك أن انخراط الحوثيين في أي عملية سياسية يمنية يعني بالضرورة اضطرارهم لتقديم تنازلات، وربما الدخول في ترتيبات تضمن عدم استمرار ترسانة الصواريخ بعيدة المدى خارج رقابة الدولة.
وإن تم ذلك فسيشكل نزعًا لمخلب إيراني طويل طالما هدد أمن الخليج. باختصار، إن “رهان الحوثي” بالنسبة لإيران بات أقل جدوى مما كان عليه، وقد يتحول من مصدر قوة لنظام طهران إلى عبء إذا مضت التسوية وأُجبر الإيرانيون على التخلي عن دعم الحرب علنًا.
على ضوء ما تقدم، يتضح أن إستراتيجية طهران الإقليمية القائمة على رهان الميليشيات تواجه تراجعًا ملموسًا. فدول المحيط المعنية بتلك الميليشيات بدأت تعيد تقييم مواقفها وتتحرك لحماية سيادتها: العراق لم يعد ساحة مفتوحة دون ثمن، وشعبه ضاق ذرعًا بالميليشيات وولائها الخارجي؛ لبنان الرسمي كسر جدار الصمت ورفض علنًا هيمنة سلاح حزب الله وما يستجلبه من عزلة وعقوبات؛ اليمن يقترب من إنهاء حربه المدمرة ولو بشروط تُخرج الدعم الإيراني من المعادلة.
وحتى سوريا، الحليف التاريخي لإيران، اضطر تحت الضغط العربي لتقليص مظاهر النفوذ الإيراني الاقتصادية والعسكرية على أراضيه تفاديًا لعقوبات وعزلة دولية، ما أفقد طهران امتيازات كانت تمتعت بها خلال سنوات الحرب هناك.
وإلى جانب العوامل الإقليمية، هناك تغير في الموقف الدولي أيضًا: إذ تتبنى الولايات المتحدة وحلفاؤها سياسة أكثر صرامة حيال النشاطات الإقليمية الإيرانية، وتجلى ذلك في استمرار الضربات الجوية الإسرائيلية ضد أهداف إيرانية في سوريا والعراق (بين الحين والآخر) وعدم مواجهة اعتراض دولي جدّي لها. كما أن الإدارة الأميركية – رغم انشغالها بحرب أوكرانيا وأزمة تايوان – لم تغفل عن مراقبة تحركات إيران، فعززت وجودها العسكري في الخليج صيف 2023 للتصدي لتهديدات الحرس الثوري للملاحة في مضيق هرمز.
وأخيرًا جاء تهديد الترويكا الأوروبية بتفعيل العقوبات الأممية (آلية الزناد) بمثابة تحذير لطهران بأن صبر المجتمع الدولي على خروقاتها النووية وتدخلاتها الإقليمية شارف على النفاد.
مستقبل المشروع الإقليمي الإيراني
في ضوء هذا المشهد المركب، يبدو أن مشروع النظام الإيراني الإقليمي يقف عند منعطف حرج. فالعلاقة بين الداخل والخارج في استراتيجية طهران باتت علاقة عكسية تضخّم أزمة النظام بدل حلها: كلما تفاقمت الضغوط في الداخل، لجأ النظام أكثر إلى تصديرها خارج الحدود عبر المغامرات الإقليمية؛ وكلما توسع في رهاناته الخارجية، ارتدت عليه بمزيد من العزلة الدولية والاستنزاف الاقتصادي مما يفاقم أزمته الداخلية. لقد دخلت إيران فيما يشبه الحلقة المفرغة. فمن جهة، لم يعد بإمكانها التراجع بسهولة عن مشروع التمدد الإقليمي الذي صار جزءًا من عقيدتها العسكرية والسياسية ومصدر شرعية أيدولوجية لنظام ولاية الفقيه – يتباهى قادتها علنًا بأن نفوذهم يمتد إلى سواحل المتوسط وباب المندب. ومن جهة أخرى، بات المضي قدمًا في هذا المشروع مكلفًا جدًا إلى حد يهدد بانهيار النظام من الداخل؛ فاقتصاد إيران المنهك لم يعد يحتمل تمويل المليشيات بمليارات الدولارات بينما يعيش المواطن الإيراني تحت وطأة الغلاء وانهيار العملة، والشعب الذي ضحى كثيرًا لأجل شعارات الثورة بدأ يدرك أن مغامرات النظام الخارجية تجلب له الفقر والعزلة ولا تخدم مصالحه المباشرة.
إن اشتداد الأزمة الداخلية – اقتصادًا ومجتمعًا – يضع صُنّاع القرار في طهران أمام خيار صعب: إما إعادة ترتيب الأولويات نحو الداخل والرضوخ لتسوية ما مع الغرب والجوار تكبح الاندفاع الإقليمي مقابل إنقاذ الاقتصاد وتهدئة الشارع، وإما المكابرة بالهروب إلى الأمام خارجيًا عبر تصعيد عسكري أو أمني في المنطقة لصرف الأنظار عن الداخل وتوحيد الصفوف خلف النظام باسم “مواجهة الأعداء”.
والمؤشرات الحالية تدل على أن النظام اختار نهج التصعيد والقمع في المدى المنظور بدل التهدئة والإصلاح، وذلك عبر استمرار تطوير برنامجه النووي واقترابه أكثر من عتبة السلاح النووي – ما استفز الأوروبيين للتهديد بإعادة فرض العقوبات الدولية – وكذلك من خلال تكثيف الإعدامات والاعتقالات لإرهاب الداخل، وأيضًا محاولة فتح جبهات إقليمية جديدة أو توسيع القديمة (مثال ذلك الحديث عن دعم إيراني لفصائل مسلحة في الضفة الغربية وغزة خلال حرب 2023، أو تحريك ميليشيات عراقية لاستهداف مصالح أميركية بين حين وآخر).
بيد أن هذا النهج محفوف بالمخاطر الشديدة، لأنه قد يُسرّع انفجار الداخل الذي يغلي بالغضب المكبوت، خصوصًا إذا ما أقدم النظام على مغامرة خارجية خاسرة تمنح خصومه الذريعة لإضعافه عسكريًا. ولعل حرب الأيام الاثني عشر بين طهران وتل أبيب (يونيو 2025) كانت إنذارًا مهمًا؛ فبرغم نتائجها المحدودة عسكريًا، إلا أنها هزّت صورة النظام أمام شعبه وأظهرت اختراقًا أمنيًا كبيرًا (بوصول صواريخ إسرائيلية إلى عمق إيران)، الأمر الذي شجّع المعارضة الداخلية على تصعيد نشاطها حتى سُمعت مجددًا هتافات “الموت لخامنئي” في بعض المدن، ودفع أجنحة في النظام لتبادل الاتهامات بالمسؤولية عما جرى.
أي أن تلك الحرب القصيرة عمّقت “التصدعات في أمن وشرعية النظام” وجعلت قادته “يكشفون عن خوفهم من السقوط” وفق وصف أحد الكتاب الإيرانيين.
ازاء ذلك، يذهب العديد من الباحثين إلى ترجيح أن مستقبل المشروع الإقليمي الإيراني سيتحدد إلى حد كبير بناءً على مآلات الوضع الداخلي.
فإن استمرت الأزمات الداخلية بالاحتقان دون حلول، وتصاعدت حدة المقاومة الشعبية في وجه القمع، فسيجد النظام نفسه مضطرًا إلى الانكفاء للداخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وربما تقديم تنازلات كبرى – سواء للشارع المنتفض أو للمجتمع الدولي – كالتخلي عن بعض طموحاته النووية أو كبح دعم ميليشياته، في محاولة يائسة لتفادي الانهيار الكامل. أما إذا نجح النظام (ولو مؤقتًا) في قمع الداخل وتأجيل الانفجار الشعبي، فقد يضاعف رهانه الخارجي بأسلوب أشد عدوانية، وهذا سيناريو خطير قد يقود إلى اصطدام مباشر أوسع نطاقًا مع قوى إقليمية ودولية لن تسمح لإيران بتهديد استقرار المنطقة أكثر.
وفي كلتا الحالتين، أصبح واضحًا أن الهوامش القديمة المتاحة أمام طهران للمناورة تضيق يومًا بعد يوم. فدول الجوار المدعومة دوليًا لم تعد مستعدة لغض الطرف عن نشاطات إيران التخريبية، والصوت الدولي الرافض لسياسة طهران بات أعلى من أي وقت مضى. وفي الداخل، ورغم كل مظاهر القبضة الحديدية، فإن روح الاحتجاج والمقاومة لم تعد قابلة للكسر أو التراجع، خاصة مع جيل شاب متعلم ومتصّل بالعالم يرفض العيش بمعزل عن الحرية والكرامة.
لعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن النظام الإيراني اليوم يقف أمام لحظة الحقيقة: فإما أن يتجه نحو المصالحة مع شعبه وجيرانه عبر تغيير نهجه جذريًا في الداخل والخارج، وإما أن يستمر في مشروع الهيمنة والقمع ليفرض نفسه بالقوة، وحينها قد يواجه مصير الأنظمة التي رفضت الإصغاء لصوت شعوبها حتى سقطت تحت وطأة انفجار الداخل أو ضربات الخارج. إن تشابك المأزق الداخلي الإيراني مع رهاناته الميليشياوية الخارجية يشي بأن أي انفجار في أحدهما سيمتد تلقائيًا إلى الآخر.
ومن هنا، فإن مستقبل المشروع الإقليمي الإيراني أصبح معلقًا بخيط رفيع: نجاحه بات مشروطًا باستقرار الداخل الإيراني وهذا مستبعد حاليًا، وفشله سيزداد ترجيحًا كلما اشتد الضغط الإقليمي والدولي لاحتواء نفوذ طهران.
وعلى ضوء الوقائع الراهنة، يميل ميزان الترجيح نحو تضاؤل ذلك المشروع الإقليمي شيئًا فشيئًا؛ فقد بدأ “محور المقاومة” الإيراني بالتفكك تحت ضربات متزامنة – انتفاضات شعوب في الداخل وضغوط ورفض في الخارج– الأمر الذي قد يمهد لشرق أوسط جديد أقل خضوعًا لسطوة المشروع الإيراني وأكثر تعاونًا على أساس احترام السيادة المتبادلة.
وربما ستكون الشهور والسنوات القليلة المقبلة حاسمة في الإجابة عن سؤال لطالما شغل المراقبين: هل يتغير سلوك النظام الإيراني تحت ضغط الأزمات، أم أن التغيير سيأتي بإرادة الشعوب لتطوي صفحة أربعة عقود من المغامرات الأيديولوجية وتدخلات الحرس الثوري في المنطقة؟